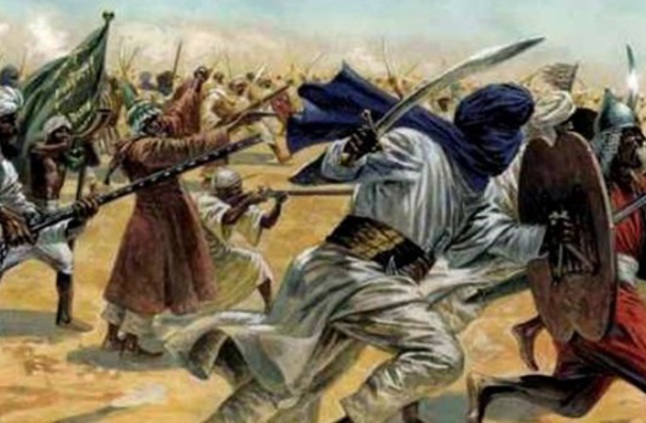العولمة والإرهاب، طرفًا المعادلة السياسية المتغيرة في العالم خلال القرن الحالي،
ويؤثر الطرفان على نظرة الشعوب لمستقبلهم، فوفقًا لدراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، التي شملت 1.5 مليار شخص، من 60 دولة، في أواخر عام 2006، فإن 48% من
سكان الكرة الأرضية يتوقعون مستقبلًا مظلمًا للأجيال القادمة؛ لأنهم سيعانون من
فقدان الأمن والسلام، بسبب متغيرات العولمة والإرهاب.
ونظرًا لأهمية العلاقة بين الطرفين،
باعتبارهما طرفي صناعة المستقبل، فقد تناول الباحث الأردني «سعود فياض» تلك الإشكالية
البحثية لدراسته للماجستير بكلية الآداب بجامعة اليرموك بالأردن، التي جاءت تحت
عنوان «الأثر المتبادل بين العولمة والإرهاب».
ورأى الباحث أن الطرفين معقدان بما فيه
الكفاية، وبالصورة التي لا تسمح بفهم الأحداث بصورة بسيطة، فنحن أمام شبكة
متقاطعة ومتداخلة من من الأنظمة، فعلى جانب العولمة، هناك الحكومات والشركات
والمنظمات الدولية، وعلى جانب الإرهاب، فهناك القوى الداعمة، والدعم المالي
واللوجستي، إضافة إلى العنصر البشري القادم من مختلف دول العالم.
وتناول الباحث الطرفين في الفصل الأول،
وذلك من خلال مبحثين، ويدور المبحث الأول حول مفهوم وأطراف العولمة، وتعريفها
وأبعادها، والمبحث الثاني حول الإرهاب، والمقاربات والاتجاهات المعاصرة له، إضافة إلى هيكلته وأنماطه المختلفة.
العولمة
العولمة، وفقًا لما نشره الباحث الأردني، هى الطريقة الإجرائية التي يزداد من خلالها الترابط ما بين الأسواق بالدول، ويأتي ذلك كنتيجة لديناميكية تبادل الخدمات والسلع وحركة رأس المال، كما تلعب المنظمات المستقلة، والأفراد دورًا متزايدًا في عملية الربط ما بين الشعوب، بصورة تفوق الدور الحكومي.
ويرى الباحث أن الإرهاب مفهوم «معولم»؛ لأنه متشعب، ويثير الجدل ما بين العلماء في الدول المختلفة من العالم، ويعد التعريف الفرنسي من أكثر التعريفات شمولًا؛ حيث يعتبر الإرهاب عملًا مُستهجنًا، يتم ارتكابه بواسطة أجنبي في إقليم دولة؛ بهدف ممارسة الضغط في نزاع لا يعد ذا طبيعة داخلية.
وتناول الباحث ظاهرة الإرهاب تاريخيًّا، بداية من حركة «المخنجرين» في القرن الأول الميلادي، مرورًا بالحركات الإسلامية التي اعتمدت على العنف كـ«القرامطة»، وانتهاءً بأحداث 11 من سبتمبر، وما جاء بعدها من أحداث في مختلف دول العالم.
كما أبرز قضية التفريق بين الاستخدام الشرعي وغير الشرعي للعنف، مؤكدًا أن عملية التفريق بينهما تعتمد في الأساس على وجهة النظر السياسية، والآليات التي تتبعها كل دولة، وتراها صحيحة؛ لاستخدام حقها الشرعي في القوة.
وفي الفصل الثاني، تناول الدارس قضية القياس الكمي لظاهرتي العولمة والإرهاب، وتعد هذه الخطوة من الخطوات المهمة؛ نظرًا لأن الدراسات السابقة اعتمدت على المنهج الوصفي والتاريخي.
وأبرز الباحث مؤشر العولمة الخاصة بمؤسسة كارني Kerany، الذي يهدف إلى قياس درجات العولمة من خلال أبعادها المختلفة؛ حيث قدمت المؤسسة أربع مؤشرات رئيسية مثل مؤشر التكامل الاقتصادي والمالي، ومؤشر الارتباط التكنولوجي، ومؤشر الارتباط الشخصي، ومؤشر الارتباط السياسي.
أما مؤشر التكامل الاقتصادي والمالي، ويهدف إلى معرفة دور التجارة الدولية، والاستثمارات الأجنبية، والتدفقات المالية العالمية في اعتماد الدول على بعضها البعض في إطار الاقتصاد العالمي، كجزء من العولمة الدولية، ويعتمد هذا المؤشر على عاملين فرعيين، الأول الاستثمارات الأجنبية المباشرة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات التجارة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وهناك مؤشرات الارتباط التكنولوجي، التي تهدف إلى معرفة دور البعد التكنولوجي للعولمة بعملية ربط الأفراد والدول بالمجتمع العالمي، وذلك اعتمادًا على مؤشرات فرعية، الأول النسبة المئوية لعدد مستخدمي الإنترنت بالنسبة لعدد السكان، ونسبة عدد الشبكات بالنسبة لعدد السكان لكل مليون مواطن، ونسبة مزودي خدمات الإنترنت الآمنة بالنسبة للعدد الكلي لكل مليون مواطن.
إضافة إلى مؤشر الارتباط الفردي، والذي يهدف إلى اكتشاف البعد الاجتماعي والحضاري للعولمة، وذلك من خلال مؤشر عدد السياح الكلي وقسمته على عدد السكان الإجمالي، وعدد المكالمات الدولية بالدقائق بالنسبة لكل فرد، ونسبة حوالات العاملين بالخارج من الناتج المحلي الإجمالي.
ومؤشرات الارتباط السياسي، التي تهدف لمعرفة انفتاح الدولة على العالم الخارجي من الجانب السياسي، واعتمادًا على عدد الاتفاقيات الدولية التي صادقت الدولة عليها، وعضويتها بالمنظمات الدولية، وحجم المشاركة بمهمات حفظ السلام، ومؤشر الحوالات.
وعلى جانب قياس ظاهرة الإرهاب، فقد لعبت العولمة دورًا في تغيير الكثير من المُسلمات في الجانبين السياسي والأمني، لذا فقد شهد مفهوم الإرهاب الكثير من التباين في التعريفات؛ ما أثر على إيجاد مقاييس مناسبة له.
واعتمد الباحث على مقاييس مختلفة، مثل مؤشرات الإرهاب لدى وزارة الخارجية الأمريكية، ويشمل المقياس عدة عناصر، مثل عدد العمليات الإرهابية التي وقعت في الدولة، وعدد القتلى والجرحى بها، إضافة إلى التوزيع الجغرافي للهجمات، وعدد الجماعات الإرهابية، والتكرار الزمني لها.
وهناك مؤشرات مؤسسة بنكرتون لخدمة المخابرات العامة، وهو أكثر شمولًا من مقياس وزارة الخارجية الأمريكية، ويتناول عدد الحوادث الإرهابية سنويًّا، وعدد الجماعات الإرهابية وأنواعها، وتوزيعها جغرافيًّا، وعدد المنفذين، وطبيعة الأسلحة المستخدمة وأنواعها.
إضافة إلى مؤشرات مؤسسة راند والمعهد الوطني الأمريكي لمنع الإرهاب، والذي يضمن متغير عدد الحوادث، والجماعات الإرهابية، وطبيعة الأهداف.
ويلاحظ أن هذه المؤشرات تتفق جميعها في المتغيرات والمقاييس التي تعتمد عليها، ويرجع ذلك إلى أن الإرهاب وعلى الرغم من تعدد تعريفاته، إلا أنه يعتمد على مجموعة من المتغيرات والنقاط التي تدور حولها تلك التعريفات، مثل مدى قوة العملية الإرهابية، وأهدافها، والنطاق الجغرافي لها.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من ضمنها أن العلاقة ما بين العولمة والإرهاب علاقة طردية إيجابية؛ حيث تزيد ظاهرة الإرهاب في الدول كلما زادت ظاهرة العولمة.
كما أن هناك زيادة في استخدام مخرجات التكنولوجيا الحديثة الناتجة عن العولمة في العمليات الإرهابية؛ حيث زودت تلك المخرجات الشبكات الإرهابية بأدوات لا حصر لها، مكنتها من نشر أفكارها وعملياتها، وابتزاز الدول الكبرى، ويرجع ذلك إلى رخص تكلفة استخدام تلك الأدوات التكنولوجية.
ويتضح أن شعوب بعض الدول يشعرون بأن العولمة تزيد من أزماتهم، والعقبات التي تقف أمام تقدمهم، لذا لجأ بعض الأفراد إلى العمليات الإرهابية، وهو ما يفسر العلاقة الارتباطية ما بين العولمة والإرهاب.