تجديد الخطاب الديني.. سنة إلهية وضرورة حياة
الخميس 28/يونيو/2018 - 01:53 م
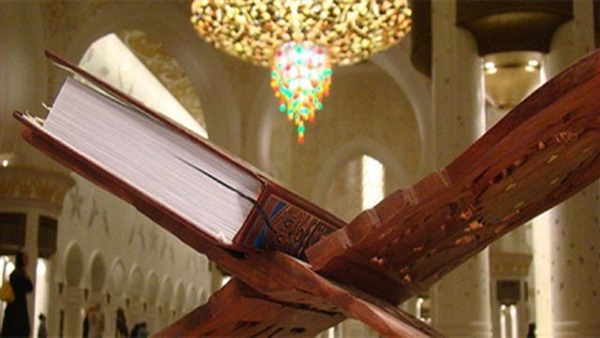
محمود محمدي
ما المراد بـ«تجديد الخطاب الديني»؟ ومَنْ هم المجددون؟ وما الشروط الواجب توافرها فيمن يتصدى لمهمة التجديد؟ وهل هذا العلم حكر على أشخاص معينين أم أن أي مسلم يحق له الغوص في هذا البحر الخضم؟ أسئلة كثيرة نجيب عنها في التقرير التالي.
و«التجديد»، هو سنة إلهية وضرورة حياة؛ لأنه فهم صحيح للشريعة الإسلامية، يُدرك من خلاله «المجدد» أن الدين إصلاح للحياة، وليس طقوسًا وأشكالًا، وهو ما قام به الخليفة عمر بن عبدالعزيز، حين أطعم الأفواه الجائعة بدلًا من أداء بعض الطقوس، كما يتجلّى فيما قام به الإمام الشافعي الذي أمضى الليلة يفكر في حلول لمسائل فقهية، مؤثرًا ذلك على أداء بعض النوافل.
وجاء في لسان العرب أن التجديد في اللغة: إعادة الشيء إلى سيرته الأولى، ومن ذلك قولهم: جدد الثوب تجديدًا، أي صيره جديدًا، وتجدد الشيء تجددًا أي صار جديدًا، وفي الاصطلاح الشرعي هو اجتهاد في فروع الدين المتغيرة، مقيد بأصوله الثابتة، وقد فسر العلماء الأقدمون التجديد الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا» بأنه العودة إلى العمل بالكِتاب والسُّنَّة، وإزالة ما غشيها من البِدَع والضلالات، أو إحياء ما اندرس من العلوم وإبرازها للناس، وبيان محاسن الإسلام وإيضاح صورته الحقيقية، وإزالة ما علق بهذه الصورة من شوائب، وكذلك النظر في كل مسائل القُدَامى، وكتب التراث بالتحقيق والدراسة، كما عرفوا المجدد بأنه: «من له حنكة رد المتشابهات إلى المحكمات، وقوة استنباط الحقائق والدقائق والنظريات من نصوص الفرقان وإشاراته ودلالاته».
أما علماء العصر الراهن فيرون أن التجديد الذي يتماشى مع أحوال الناس وقضاياهم المعاصرة؛ يتمثل في إمعان النظر في نصوص القرآن والسُّنَّة والأحكام الفقهية، وإعادة قراءتها قراءة ملتزمة بكل القواعد التي حرص أئمة التفسير والحديث والأصول، بهدف تحديد الموقف الشرعي من القضايا المعاصرة المُلحَّة التي تتطلب حلًّا شرعيًّا يطمئن إليه العلماء والمتخصصون.
ولقب «المجدد»، ومصطلح «التجديد»، اقتبسا من نص قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا».
و«المُجدد» هو «الَّذي يُعيد تكوين جُزء من كائن حيّ أُصيب بأذىً» (حسبما ورد في قاموس اللغة)، وقد أطلق العلماء والمؤرخون هذا اللقب على كل مجتهد جدد للأمة دينها، وشرع لها فقهًا معاصرًا يتماشى وقضايا العصر الذي يعيش فيه، وأزال عنها كل لبس في جوانب الدين.
واشترط العلماء والمتخصصون شروطًا يجب توافرها فيمن يتصدى لمسألة الاجتهاد أو التجديد، نذكر منها:
(1) اشتراط صحة العقيدة وملازمته للسنة النبوية.
(2) العلم بالقرآن الكريم وما تضمنه من الأحكام محكمًا ومتشابهًا، وعمومًا وخصوصًا، ومجملًا ومفسرًا، وناسخًا ومنسوخًَا.
(3) العلم بسنة النبي الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله وأفعاله، وطرقها في التواتر والآحاد، والصحة والفساد، وما كان منها على سببٍ وإطلاقٍ.
(4) العلم بأقوال السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه، ليتبع الإجماع ويجتهد في الرأي مع الاختلاف.
(5) العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها، حتى يجد المجتهد طريقًا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل، فهذا ما لا مفر للمجتهد عنه ولا يجوز له الإخلال بشيء منه.
(6) أن يكون عالمًا بالقدرِ اللازم لفهم الكلام من اللغة والنحو.
(7) أن يكون على علم بأصول الفقه؛ لأن هذا الفن هو الدعامة التي يعتمد عليها الاجتهاد أو التجديد.
(8) أن يكون متجردًا من الأهواء؛ فالمجدد لابد أن يكون باحثًا عن الحقيقة، سواء كانت متفقة مع ميوله أو لم تتفق ومتمسكًا بالحق بعيدًا عن الأهواء الباطلة والتقليد الأعمى.
(9) أن يكون متمسكًا بثوابت الدين وقواعده؛ فلا يجوز تجديد مع تحريف العقيدة، وأن يكون القصد من التجديد هو إصلاح الفكر الديني وتوعية الناس بما يتلاءم وظروف العصر الذي يعيشون فيه.
ويؤكد الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، فرع القاهرة، أن من يتصدى لقضية التجديد يجب أن تتوافر فيه شروط الاجتهاد وأدواته وهي كثيرة جدًّا، أولها اشتراط صحة عقيدة المرء وملازمته للسنة، وأن يكون محصلًا لجملة من العلوم أوصلها البعض إلى 19 علمًا شرعيًّا ولغويًّا وتاريخيًّا، أهمها: العلم بالفقه وقواعده وأصوله، والقراءات وتوجيهها، وأصول الحديث، وأحوال البشر وعادات الناس، ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها تطبيق عملي للقرآن، وإجادة النحو والتصريف والاشتقاق وغير ذلك من فروع اللغة، وتحصيل علوم البلاغة من معانٍ وبيان وبديع، وهناك شرط مهم يجب توافره فيمن يتصدى للاجتهاد، وهو أن يكون عالمًا بالأدب؛ قديمه وحديثه، أو ما يُسمى ديوان العرب.
«العواري»، يوضح أن اشتراط العلم بالأدب ينبع من أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذلك لا يستطيع إنسان تفسير لفظ فيه وهو لا يعرف ديوان العرب، ومن الأدلة على هذا قول سيدنا عمر بن الخطاب: «عليكم بديوان العرب، فإن فيه تفسيرًا لكتاب ربكم»؛ فمن لم يكن حافظًا للشعر قديمه وحديثه كيف يفسر آية أو كلمة من القرآن؟ كل هذه أدوات يجب أن يملكها كل من يريد أن يجتهد في أي علم، ومن لا يملك هذه الأدوات ويتقنها ويتضلع فيها عليه أن يُحجم عن الخوض في هذا الشأن وإلا أضاع نفسه.











